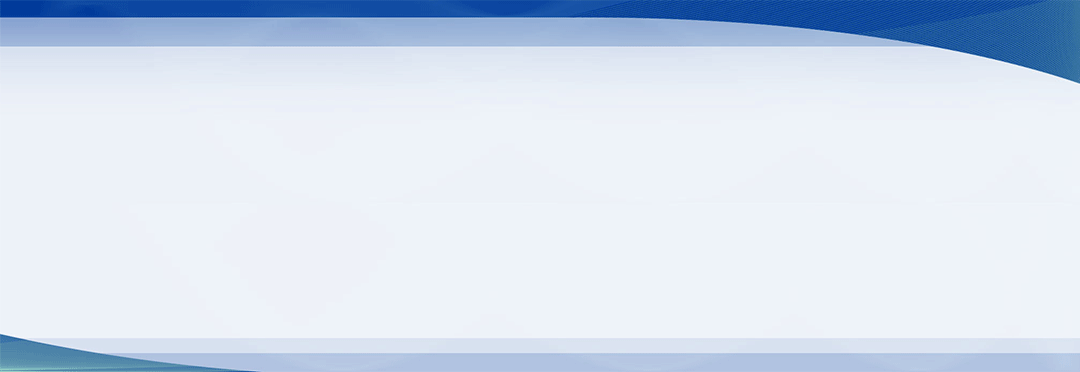أسماء مُستعارة للذات: من القلق إلى الاكتئاب إلى اضطراب المزاج

بدر مصطفى
كانت تلك واحدة من اللحظات التي يسميها الكثيرون أزمة منتصف العمر. واجهت حينها فراغًا داخليًّا يتسع يومًا بعد يوم، وفقدتُ فيها القدرة على تذوق أبسط تفاصيل الحياة، وأصبحت أنظر إلى إنجازاتي وكأنها صفحات قديمة لم تعد تخصني. النوم صار متقطعًا، والشهية متذبذبة، والقلق يطلّ برأسه ليل نهار. توترت علاقتي بكل من حولي وتنامى لدي شعور بالعزلة والرغبة في الهروب إلى اللامكان. كانت الذكريات تلاحقني بثقلها، والمستقبل يلوح أمامي جدارًا غامضًا لا منفذ فيه.
رشح لي أحد الأصدقاء طبيبًا نفسيًا معروفًا، وقال إن الزيارة قد تعيد ترتيب الفوضى التي تسكنني. ورغم قناعتي أنني وحدي من يستطيع التغلب على الأزمة، استجبت وقتها للفكرة. أتذكر أنني بعد تلك الزيارة جلست أدوّن تفاصيل التجربة، وثمة شعور بداخلي بأنني سأعود إليها مستقبلًا. واليوم، بعد أن تجاوزت الأزمة، أستدعيها متأملًا ومشاركًا بعضًا من أفكاري حولها.
أبدأ بأن أعيد نقل ما كتبته في مذكرتي عن انطباعات الزيارة الأولى لعيادة الطبيب النفسي.
دخلتُ قاعة الانتظار لعيادةٍ بالغةِ الفخامة مُجهزة بعناية فائقة. توجهت إلى موظفة الاستقبال فقدمتْ لي استمارةً مطبوعة تحتوي على أسئلة عن النوم، وعن الشهية، وعن القلق في الأماكن العامة، وأيضًا عن علاقتي بالآخرين. قرأتها ببطء وجاوبت عن الأسئلة بصدق، رغم عدم ارتياحي للإجراء نفسه كونه يختزل المشاعر والتجارب في مربعات صغيرة تنتظر علامة بالقلم. تحولت فترة انتظاري إلى محاولات لترتيب الأفكار، من أين سأبدأ الحديث مع الطبيب؟ وما الأعراض التي ينبغي أن أركز عليها؟ وهل يتوجب علي تقديم نسختي الكاملة عن ذاتي أم ثمة أمور لا داعي لذكرها؟ لماذا أشعر بضغط نفسي وتوتر من هذا اللقاء!
حين نُودي اسمي، دخلتُ الغرفة. لَفَتَ نظري قسوةُ الضوء الذي ينسكب على الجدران البيضاء حتى يمحو عن المكان أي ظلال. يجلس الطبيب الخمسيني المعروف وراء مكتب مرتفع قليلًا، يُقلّب ملفًا كما لو كان يراجع أوراق قضية. ثم رفع عينيه متفحصًا ومُرحِّبًا بود. سألني عن تاريخي الطبي بنبرة مهنية محايدة. يداه تتحركان بثبات فوق الورق، وتُسجّلان كل كلمة، وكل حركة، وربما أيضًا اختلاف نبرات صوتي عند الحديث. لماذا سيطر على الإحساس وقتها بأنني أراقب نفسي من الخارج وأنا أتكلم!
عندما انتهيت واستمعت إلى رأي الطبيب، أدركت أنني سأخرج من الغرفة حاملًا اسمًا جديدًا مُعَدًّا سلفًا: قلق عام، أو اكتئاب، أو اضطراب، وأن ذاتي بكل ما حملته من خوف ومراجعة وارتباك بسبب أزمتي، قد تحولت إلى خانة في جدول جاهز للأمراض النفسية.
ما شعرتُ به في تلك الأيام لم يكن مرضًا بالمعنى الذي تحاول اللغة الطبية أن تفرضه، بل كان اهتزازًا داخليًا له اسمه في الثقافة والتجربة الإنسانية: أزمة يتكثف فيها الماضي بثقله ويطلّ المستقبل فيها جدارًا صامتًا، حيث يسأل المرء نفسه عن جدوى ما أنجزه، وعن معنى ما تبقى له من سنوات.
الأرق، وتذبذب المزاج، والقلق الوجودي، كلها لم تكن أعراض خلل عضوي، بل علامات على صراع داخلي بين ما مضى وما سيأتي.
غير أن ما واجهني في العيادة لم يعترف بكل هذا. إذ لم تر اللغة الطبية سوى بنود قابلة للتصنيف: اضطراب قلق عام، أو اكتئاب متوسط، أو خلل في المزاج. تحولت الأزمة التي كانت جزءًا من مسار حياتي إلى خانة إكلينيكية فَقَدَتْ كل سياقها الشخصي، و إلى مصطلح يمكن تداوله بسهولة. لم يسألني الطبيب عن معنى ما أمرّ به، ولم يتوقف أمام أسئلتي عن العمر والزمن والمستقبل، بل حرص على أن يترجم كل شيء إلى علامات يمكن إدراجها في الدليل التشخيصي.
هكذا ضاع الطابع الوجودي للأزمة، وضاعت معه فرديتي. لم يعد ما أعيشه حدثًا إنسانيًا طبيعيًا، وإنما نسخة أخرى من حالة متكررة تُعامَل بالدواء نفسه والجلسات نفسها. تشخيص كهذا لا يعترف بالإنسان، بل يعترف فقط بالنموذج.
***
في الثقافة المعاصرة يظهر المرض النفسي بوجه محايد ومقنع في آن واحد. يُقدَّم بوصفه حقيقة موضوعية، ويُسوَّق في الكتب الإرشادية على أساس كونه معرفة قطعية لا تحتاج إلى مراجعة. تتكرر العبارات نفسها في حملات التوعية والإعلانات والندوات: «الاكتئاب مرض مثل أي مرض عضوي»، «القلق خلل كيميائي في الدماغ»، «الاضطراب ثغرة في برمجة الجهاز العصبي». هذه اللغة لا تترك مجالًا للشك، بل تحاصر الفرد بسلطة العلم المصاغ في صورة أرقام ورسوم بيانية وتجارب مخبرية..
هكذا يغدو التشخيص أشبه بملصق لامع على علبة دواء، يَعِد بالسيطرة على معاناة الفرد بمجرد إدراجه تحت اسم محدّد. وتساهم برامج الترويج الإعلامي في تكريس هذه الصورة؛ تقارير سريعة تشرح الفرق بين القلق العابر واضطراب القلق العام، وقوائم جاهزة للتمييز بين المزاج السيئ والاكتئاب السريري، وإعلانات لبرامج علاجية تعتمد على الجلسات الرقمية والتطبيقات الذكية. كل ذلك يشيع فكرة أن الاضطراب النفسي يمكن أن يُختزل إلى تعريف دقيق، وأن الحلول موجودة على بُعد نقرة أو وصفة.
الوجه الظاهر يوحي بأن العلم قد أتمّ مهمته، وأن النفس البشرية لم تعد لغزًا عصيًا بل حالة قابلة للتشخيص والتقنين. يكرر الأطباء المعادلة نفسها في العيادات، وترفدها الشركات الدوائية بمنتجات جديدة، والمجتمع يتبناها بوصفها منظومة تفسيرية تمنحه شعورًا بالاطمئنان. وهكذا يستقر في الوعي العام أن المرض النفسي حقيقة صلبة، وأن التشخيص خريطة لا تحتمل التأويل، وأن العلاج المعياري يكفي لإعادة الفرد إلى مساره الطبيعي.
حين أستعيد ذلك المشهد الآن، أستدعي ما كان يقصده فوكو حين كتب عن تاريخ الجنون.
فما جرى في الغرفة لم يكن مجرّد محاولة للفهم أو للعلاج، بل ممارسة لسلطة ترتدي ثوب المعرفة. لم يكن الطبيب شخصًا يصغي إلى ذاتي، بل ممثلًا لمنظومة كاملة تسعى إلى تحديد ما هو طبيعي وما هو مختلّ. والأزمة التي عشتها لم تُعامَل بوصفها حدثًا إنسانيًّا، بل خللًا في نظام ينبغي إصلاحه، وكأن الذات لا تُعرّف بذاتها بل بما تقوله عنها السلطة الطبية.
لقد كشف فوكو أن الجنون لم يكن يومًا اكتشافًا بريئًا، بل بناءً اجتماعيًا أعيد من خلاله توزيع الحدود بين العقل واللاعقل.
ومع الطب النفسي الحديث انتقلت هذه الآلية من المصحات المغلقة إلى العيادات اليومية. فالجسد والنفس يُعاد كتابتهما في جداول ومعايير بوصفهما بيانات قابلة للضبط.
هذا المنطق في واقع الأمر يعمل على إنتاج المريض نفسه، حيث يخرج المرء من العيادة وهو يحمل اسمًا جديدًا ليس من اختياره، بل من اختيار الجهاز المعرفي-السلطوي الذي يصنّفه. ومن تلك اللحظة يُعاد دمجه في المجتمع بصفته مريضًا يحتاج إلى علاج، أي كيانًا ينبغي إخضاعه لمنظومة المراقبة والمتابعة والتقويم. تختفي ذواتنا الفريدة، بما تحمله من ارتباك وأحلام وخيبات، وراء القناع الذي صاغته لها السلطة الطبية، وهو قناع يسهُل التحكم به لأنه يتكلم بلغة نمطية موحدة.
الهدف غير المعلن من هذه المنظومة ليس تحرير الفرد من معاناته، وإنما إعادة تأهيله ليصبح أكثر قابلية للاستمرار.
فالمجتمع يحتاج إلى عامل منتِج لا إلى ذاتٍ مشغولة بأسئلتها، والشركة تحتاج إلى موظف قادر على إنجاز المهام لا إلى شخص يتأمل هشاشته.
وعندما يُقاس نجاح العلاج بقدرة المريض على العودة إلى العمل أو الالتزام بالجدول اليومي، يتضح أن المسألة لا تتعلق بالشفاء بل بالضبط الناعم.
تخلق الأدوية والجلسات وهم الطمأنينة، لكنها لا تقترب من الجرح الحقيقي. بل على العكس، تساهم في إعادة تغطيته بطبقات جديدة من اللغة والمعايير، فيُعاد إدماج الفرد داخل النسق الاجتماعي وقد صار أكثر خضوعًا لما يُطلب منه. وبذلك يتحول العلاج من وعد بالشفاء إلى وسيلة لتثبيت المعيارية، حيث يُعاد إنتاج الفرد بصفته كائنًا صالحًا للاستعمال، وليس ذاتًا تبحث عن معنى يتجاوز القوالب الجاهزة.
الطب النفسي في صورته السائدة لا يواجه الألم، بقدر ما يُروِّضه. ولا ينصت إلى المعاناة، بقدر ما يُكيّفها مع الإيقاع العام ويمحوها تحت أسماء جاهزة. وما يُسمى شفاءً ليس سوى وجه آخر للانضباط: جسد مطيع، ونفس قابلة للقياس، وكائن يعيد أداء دوره بلا إزعاج.
ومع ذلك، لا يمكنني الزعم بأن الطب النفسي عديم الجدوى أو أن مساعيه بلا قيمة، فالتدخل العلاجي قد يكون طوق نجاة في لحظات الانهيار الحاد، وقد يفتح للفرد بابًا للتخفف من أثقال لا يطيقها وحده. إنما ما أردت الإشارة إليه أن التجربة الإنسانية أوسع من أن تُختزل في خانة، وأن الألم لا يُقاس فقط بمؤشرات إكلينيكية ولا يُعالج دائمًا بوصفة معيارية. فبين اللغة الطبية الجاهزة والذات الباحثة عن معنى ثمة فجوة لا يردمها إلا الاعتراف بفرادة كل تجربة إنسانية معاشة، ووضع المعاناة في سياقها الإنساني قبل إدراجها في أي جدول تشخيصي.
المصدر: معنى